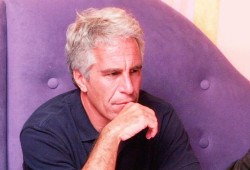كتبت أليسا ميلكانجي، الباحثة البارزة غير المقيمة في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط بمؤسسة أتلانتيك كآونسل، وأستاذة التاريخ المعاصر لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بجامعة سابينزا في روما.
يشكّل حوض النيل نظاماً بيئياً عابراً للحدود ومسرحاً دائماً للتجاذب الجيوسياسي؛ فالمياه تتدفق عبر الدول، لكن السيادة لا تتبع مجراها. هذا التناقض القديم يظل يحكم علاقة مصر والسودان وإثيوبيا.
يشير المقال، الصادر عن أتلانتيك كآونسل، إلى أن فيضاناتٍ شديدة ضربت هذا الشهر محافظات مصرية عدة مثل البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية بعد أمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبية، ما أعاد تفجير الخلاف حول سدّ النهضة الإثيوبي الكبير. أدانت وزارة الري المصرية إدارة إثيوبيا “المتهورة” للمياه، معتبرةً أن إطلاق كميات مفاجئة من السد فاقم الفيضانات، بينما نفت أديس أبابا الاتهام مؤكدةً اتباعها البروتوكولات الفنية وأنها حدّت من أضرار أكبر في السودان.
أزمة تتجدد ومواقف دولية متباينة
يتزامن هذا التوتر مع تحوّل دبلوماسي لافت، إذ أعلن المستشار الأمريكي مسعد بُلّوس أن واشنطن تدعم “نهجاً تقنياً لا سياسياً” لحل الأزمة، بما يعني التركيز على الشفافية في البيانات والتنسيق الفني بدلاً من الضغوط السياسية. تحذّر القاهرة من أن الملء السريع أو التصريف غير المنسق قد يخلّ بتدفق المياه، ويُغرق الأراضي الزراعية أو يزيد مخاطر الفيضانات في سنوات الأمطار الكثيفة.
يقع السدّ، الذي بلغت تكلفته نحو خمسة مليارات دولار ويبعد أربعة عشر كيلومتراً عن الحدود السودانية، على النيل الأزرق بطاقة استيعابية تبلغ 74 مليار متر مكعب، وهو أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا. بعد الملء الرابع والأخير عام 2023، أعلنت إثيوبيا تشغيل السد بالكامل لتتضاعف قدرتها الكهربائية وتقترب من هدفها بأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
لكن المخاطر على دلتا النيل تبدو فورية وهيكلية معاً: فالإطلاقات الكبيرة أو غير المنسقة يمكن أن تغرق نظم الصرف القديمة وتعطل الري، بينما يغيّر تشغيل السدّ في المدى الطويل أنماط الجريان الموسمي ويؤثر في إعادة تغذية المياه الجوفية وملوحة الأراضي. ويعتمد أكثر من 118 مليون مصري على النيل في 97% من احتياجاتهم المائية، في حين انخفض نصيب الفرد من المياه من 1900 متر مكعب عام 1959 إلى أقل من 600 حالياً، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 500 بحلول 2050، أي إلى مستوى الندرة المطلقة.
إرث استعماري وصدام قانوني
تعود جذور الأزمة إلى اتفاقات استعمارية أبرزها اتفاق 1929 بين مصر والسودان وبريطانيا، الذي منح القاهرة 48 مليار متر مكعب وسودان 4 مليارات، وحق الفيتو على مشاريع المنبع. لم تشارك إثيوبيا في الاتفاق ورفضت شرعيته، وكذلك اتفاق 1959 الذي ثبّت الامتيازات لمصر والسودان دون إشراكها. ترى أديس أبابا أن تلك المعاهدات فقدت صلاحيتها التاريخية، بينما تصر القاهرة على “حقوقها التاريخية” في مياه النهر.
مع بدء بناء السد عام 2011، تصاعدت الخلافات رغم وساطات الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والبنك الدولي. لم تتوصل الأطراف حتى اليوم إلى اتفاق ملزم حول إدارة السد في حالات الجفاف أو الفيضانات، ما يترك مصير النهر معلّقاً بقرارات أحادية. وتربط القاهرة أمنها القومي بتدفق النيل، معتبرةً أي تهديد للمياه خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
نحو إدارة مشتركة ومستقبل متوازن
يؤكد المقال أن حوكمة حوض النيل تعاني ثلاثة عجزات متداخلة: فني، يتمثل في غياب بيانات لحظية عن التصريف والتدفقات؛ تشغيلي، يتمثل في غياب قواعد متفق عليها لإدارة الجفاف والفيضانات؛ وسياسي، بسبب انعدام الثقة وتضارب السرديات الوطنية. ويقترح إنشاء لجنة فنية ثلاثية مستقلة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لتحليل البيانات الهيدرولوجية وتطوير أنظمة إنذار مبكر تربط بين منصات الرصد في إثيوبيا والسودان ومصر لضمان تبادل فوري للمعلومات والتعامل المشترك مع الأزمات المائية.
كما يدعو إلى اتفاق قانوني ملزم حول آليات تشغيل السد أثناء الظروف المناخية المتطرفة، وإلى استخدام التكنولوجيا مثل المجسات التلقائية والمراقبة بالأقمار الصناعية لبناء الثقة بين الأطراف. وفي الوقت ذاته، تحتاج القاهرة إلى تسريع برامج التكيّف الداخلي، عبر تحديث شبكات الصرف ومحطات الضخ وتوسيع مشروعات تحلية المياه والتأمين الزراعي.
يختم المقال بالتأكيد على أن التعاون الفني لا يجوز أن يبقى رهينة الخصومة السياسية، فمستقبل النيل يتوقف على قدرة دول الحوض على التحول من تبادل الاتهامات إلى الإدارة المشتركة للمياه. الفشل في ذلك سيعني استمرار الفيضانات، وتفاقم انعدام الثقة، وتحول النهر إلى خط صدع إقليمي يهدد استقرار دلتا النيل والقرن الإفريقي بأسره.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-nile-at-a-crossroads-navigating-the-gerd-dispute-as-egypts-floodwaters-rise/